|
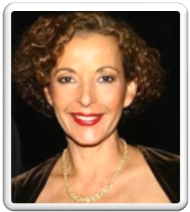  مقالات
سابقة للكاتبة مقالات
سابقة للكاتبة
راغدة درغام
(ولدت في بيروت سنة 1953) صحفية و محللة سياسية لبنانية-أمريكية تعمل مديرة
مكتب جريدة الحياة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ 1989
الانتخابات الاميركية ومخاطر النزعة الانعزالية
راغدة درغام
الجمعة ٢٦ أكتوبر ٢٠١٢
النزعة الى الانعزالية والانزواء لدى أكثرية الشعب الأميركي رسخت عقيدة
الرئيس الديموقراطي باراك أوباما القائمة على أسس تجنّب دور القيادة
الناشطة عملياً، وتبنّي الانعزالية أساساً للسياسة الخارجية، واعتماد
العقوبات وسيلة لاحتواء وعزل الأنظمة التي لا تتقبل لغة الترغيب. فلقد قرأ
باراك أوباما مزاج الشعب الأميركي على أنه ليس راغباً في تورط عسكري أميركي
أينما كان ولأي سبب كان واستنتج أن ما يريده الأميركيون هو إنهاء حروب
خاضها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وسحب الجنود الأميركيين من بؤر التوتر.
في البدء، كان للمرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني رأي مختلف قوامه الحزم
والحسم في إبلاغ العالم ان الولايات المتحدة دولة عظمى وحيدة، وستبقى، وهذا
يتطلب الانخراط والإقدام والقيادة من الأمام وليس من الوراء – عكس عقيدة
أوباما. إنما مع الاقتراب من الاقتراع، التف ميت رومني على عقيدته واتكأ
على عقيدة باراك أوباما فبات الرجلان وجهين للعملة الواحدة عندما يتعلق
الأمر بالسياسة الخارجية الأميركية – أقله الآن في الفترة الانتخابية وحتى
إشعار آخر. هذا لا يخفي بعض الاختلاف المهم في وجهات النظر أبرزته المناظرة
الأخيرة بينهما، بالذات في الشأن السوري، ليس لاختلافٍ في عناوين الدور
الكبير وإنما في التفاصيل المهمة مثل نوعية العلاقة مع المعارضة السورية،
وكيفية التعاطي مع التحدي الإيراني. ولأن هذه مرحلة الاقتتال والاستفحال من
أجل البقاء على نسق ما يقوم به الرئيس السوري بشار الأسد داخل بلاده وداخل
الدول المجاورة له مثل لبنان، لن يتمكن أي من باراك أوباما أو ميت رومني من
أن يحلق في الفضاء من نافذة المكتب البيضاوي في البيت الأبيض باسم عقيدة
الترفع والانزواء والانعزالية. ذلك ان لغة المصالح ستجبر أي رئيس أميركي
على نهج مختلف ما بعد الانتخابات لإبلاغ المستفحلين ان السياسة الأميركية
في عهد الانحسار والانزواء ليست ضوءاً أخضر للبطش والاغتيال. أما الآن، وفي
هذه الحقبة الانتقالية في الولايات المتحدة الأميركية، فإن المعارك
المصيرية على البقاء ستزداد عنفاً ودموية واستغلالاً للامتناع الأميركي عن
الانخراط. باراك أوباما يقع في عين عاصفة المسؤولية – إذا أُعيد انتخابه
رئيساً – في حال أجّل صنع السياسة للثلاثة أشهر التقليدية الى الإدارة
الثانية. ذلك ان وتيرة القتل في سورية لا تتحمل الاسترخاء بعدما وصلت أعداد
القتلى الى خمسين ألفاً على ما يقال، لا سيما ان إحدى أهم أدوات الاستقواء
هي تماماً السياسة الأميركية.
الأسبوع الماضي بلغت وقاحة الاستقواء ذروةً عندما اغتيل اللواء وسام الحسن،
أحد أهم أركان الأمن في لبنان. اللواء الحسن كشف عن أكثر من شبكة لتفجير
لبنان أبرزها على أيدي الوزير السابق ميشال سماحة الذي كان ينقل متفجرات في
سيارته من دمشق الى بيروت بأمر من كبار رجال الاستخبارات العسكرية السورية
علي المملوك، على ما نقلت وسائل الإعلام من اعترافات لسماحة بعد اعتقاله.
التحقيق ما زال جارياً وهناك داخل لبنان وداخل سورية مَن توعّد اللواء
الحسن بالعقاب المرير لتجرؤه على اعتقال سماحة وَمن يعمل على إطلاق سراح
ميشال سماحة بلا محاسبة.
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان كان رزيناً ورجل دولة عندما خطب في
توديع وسام الحسن مطالباً القضاء اللبناني أن يعجّل في قضية سماحة، رابطاً
بذلك بين الاعتقال والاغتيال من دون أن يستبق نتائج التحقيق. فإذا ما ثبت
الارتباط بين الاعتقال والاغتيال، سيكون النظام السوري حاول اغتيال الدولة
اللبنانية والأمن في لبنان في انتهاك واضح للقوانين الدولية. عندئذ يجب
الشكوى عليه في المحافل الدولية ويجب محاسبته أمام العدالة الدولية. رئيس
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وافق على مساعدة رجال التحقيق الفيدرالي
الأميركي في هذه الجريمة، وهو بدوره لفت الى احتمال الربط بين الاعتقال
والاغتيال. رئاسة الجمهورية ركّزت على أولوية الأمن والقضاء، فتحرك الجيش
للحفاظ على الأمن استدراكاً لإفرازات اغتيال الحسن. رئيس الجمهورية تبنى
موقفاً من القضاء والساسة بقوله للقضاء «لا تتردد... فالشعب معك»،
وللسياسيين داخل وخارج الحكومة «لا تؤمّنوا الغطاء» لمرتكبي الجريمة،
وللمواطنين «أنا معكم... ومع السيادة».
المعارضة الغاضبة من الاستباحة انفعلت وأخطأت إجرائياً وسياسياً بحق نفسها.
تسرّعت الى تحميل ميقاتي دم الشهيد ومطالبته بالاستقالة بدلاً من استغلال
ظرف عرضه الاستقالة على رئيس الجمهورية للإصرار على تغيير في الحكومة.
وتسرعت في تجييش العواطف والتحريض على مقر رئاسة الحكومة في السراي. وهكذا،
لم تهدر المعارضة المتمثلة بـ 14 آذار فرصة فحسب، وإنما وظفت الظرف لمصالحة
الحكومة التي تضم «حزب الله» وموالين للنظام في دمشق.
بالطبع، ان صدمة اغتيال اللواء وسام الحسن أتت لتثير السأم والقرف من مسلسل
الاغتيالات لقيادات المعارضة وأركان 14 آذار من سياسيين وصحافيين.
وبالتأكيد، كان لا بد من صرخة كفى. ذلك ان افتراض عدم اللجوء الى السلاح
«جبناً» بات ملتصقاً لا سيما بالطائفة السنية في لبنان. لكن الأمر بات أكثر
إلحاحاً نظراً لوقوع الأكثرية السنية بين مطرقة «حزب الله» وبين سندان قوى
التطرف السنّي التي شقّت طريقها في الفترة الأخيرة الى الساحة اللبنانية.
لذلك انتشر الرعب في مختلف بقاع لبنان وعواصم العالم من اندلاع حرب أهلية
تمزق البلد.
قرار التصعيد في الساحة اللبنانية لم يكن مفاجئاً. نوعية التنفيذ هي التي
أتت كمفاجأة مدهشة فضحت وقاحة لا مثيل لها. فالكل كان يتنبأ بعمليات تصدير
للأزمة السورية الى الساحة اللبنانية لتحويل الأنظار وتخفيف الضغوط عن
النظام في دمشق.
من وجهة نظر البعض، ان تلك الوقاحة سترتد على استعلاء ومكابرة النظام
السوري وحلفائه الإقليميين واللبنانيين ذلك ان حتى روسيا والصين – القطبين
الدوليين في المحور الذي يضمهما مع بشار الأسد و «حزب الله» وقادة طهران –
لن يتمكنا من مباركة استئناف مسلسل الاغتيالات في لبنان وتفجير أمنه
وسيادته.
وجهة النظر الأخرى تقول ان الآتي أعظم في هذه المعركة الشرسة من أجل البقاء
– معركة دمشق للبقاء، ومعركة طهران للبقاء، ومعركة «حزب الله للبقاء».
أصحاب هذا الرأي يتوقعون اغتيالات فاغتيالات لأن المحاسبة مستبعدة أو بعيدة
ولأن الحاجة الى البقاء أقوى من شبح الحساب.
سيؤدي هذا الى الانهيار وليس الى الانفجار، وفق رأي البعض. ذلك ان الانفجار
يعني اندلاع حروب تهدد بقاء أطراف لبنانية تخوض معركة البقاء. وهذه الأطراف
ترى ان الانهيار الداخلي في مصلحتها، أما الانفجار فإنه على حسابها.
هذا الرهان معرض للعطب والانكسار لأن اللاعبين على الساحة اللبنانية في
الحروب بالنيابة ومعارك البقاء غير قادرين على الاستفراد بالقرار – بغض
النظر إن كان أحدهم يمتلك أكبر ترسانة عسكرية أو أنه مجرد حفنة من النوع
الجديد من المقاتلين.
الخطر يكمن في استمرار سياسة الاتكاء على الاهتراء من الداخل بما يؤدي الى
انهيار النظام في دمشق – وهذه سياسة أميركية بامتياز. ذلك ان عنصر الوقت
والإطالة تخدم جميع أطياف التطرف المسلح – الحكومي وفي المعارضة – بما يهدد
بالانزلاق الى اهتراء البلد وليس اهتراء النظام. إضافة الى ان الإطالة تخدم
أيضاً فكر النظام في دمشق القائم على افتعال المشاكل في الدول المجاورة
ليكون الانهيار جماعياً إذا كان لا بد من انهيار نظام دمشق.
فهذا النظام له تاريخ حافل خارج حدوده. هو الذي خلق شرخاً وانقساماً مريراً
ومسلحاً بين الفلسطينيين بإتجار فاضح بالقضية الفلسطينية، وهو الذي يجري
الاتصالات مع إسرائيل اليوم لتنقذه. وهو الذي صدّر الإرهاب الى العراق
بعدما كان شارك في حرب نسفت العراق من المعادلة العسكرية الإستراتيجية في
منطقة الشرق الأوسط. هو الذي أقحم إيران في البطن العربي خنجراً يمزق العرب
فيما العلاقة الإيرانية – الإسرائيلية بقيت دائماً ودوماً تهادنية مهما حدث
من تصعيد عبر الحروب بالوكالة تحديداً عبر «حزب الله» في لبنان. وهو النظام
الذي ارتهن لبنان واستخدمه ورقة مساومة وخاصرة لعمقه الاستراتيجي ثم نحره
عندما تجرأ على رفض الإملاء على دستوره. وهو اليوم النظام الذي يحاول
اغتيال الدولة والأمن والقضاء لتوريط لبنان وإقحامه في الحروب بالنيابة.
ردود الفعل الإقليمية والدولية على ممارسات هذا النظام وحلفائه من الكبار
والصغار تكاد تكون اعتذارية بغض النظر عن التصريحات والتوعدات. دول مجلس
التعاون الخليجي سحبت سفراءها من دمشق – باستثناء عمان – لكنها لم تستدعِ
السفراء الروس والصينيين أو سفراءها في موسكو وبكين لإبداء امتعاضها حقاً
من السياسة الروسية والصينية المتحالفة مع طهران ودمشق.
إدارة أوباما أخفقت في الوصول الى تفاهم مع روسيا والصين أو في إبلاغهما
جدية مواقفها إزاء الملف السوري، وبالتالي، ساهمت في «حسن حظ» بشار الأسد
الذي يغرق في تمسك طهران وموسكو وبكين به في السلطة وهو يُغرِق البلاد في
حمام دم ومشروع تقسيم عبر حروب أهلية.
الانتخابات الرئاسية الأميركية لعبت دورها في اختباء القيادات الدولية وراء
الإصبع تهرباً من الاستحقاقات في سورية. إنما الآن، وبعد أسبوعين، الأجدى
بمن سيفوز بالانتخابات ان يتهيّأ للحزم والحسم برسالة واضحة لا تكتفي بما
قاله باراك أوباما حول سياسة توحيد المعارضة في سورية بدلاً من تسليحها.
فميت رومني على حق في تبني سياسة تسليح المعارضة ودعم تركيا لأن الإطالة
ستكون مهلكة ليس فقط للشعب السوري وإنما أيضاً ستكلف لاحقاً الشعب الأميركي
عندما يعود التطرف ليطرق أبوابه انتقاماً.
الأفضل والأكثر حكمة أن يتبنى الرئيس الأميركي المنتخب مواقف جدية وواضحة
بدلاً من الانسياق وراء الانعزالية. فلا أحد يتوقع من الأميركيين إيفاد
جنودهم الى هذه المعركة، وإنما مراجعة ما هو في المصلحة الأميركية وفي
القيادة الأخلاقية والفعلية للدولة العظمى الوحيدة في العالم.
|