|
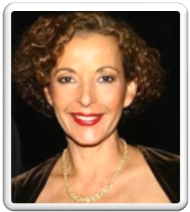  مقالات
سابقة للكاتبة مقالات
سابقة للكاتبة
راغدة درغام
(ولدت في بيروت سنة 1953) صحفية و محللة سياسية لبنانية-أمريكية تعمل مديرة
مكتب جريدة الحياة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ 1989
السياسة الأميركية في خانة «اللافعل» حتى
انتخابات الرئاسة
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٢
تتزاحم المبادرات الارتجالية المتسرعة في تناولها المسألة السورية البالغة
الأهمية فيما واقع الأمر يفيد بأن الأكثرية الدولية تصطف أو تختبئ وراء
انتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية. اقتراب موعد الانتخابات عزز
الرغبة الأميركية – لدى المرشحين الجمهوري ميت رومني والديموقراطي الرئيس
باراك أوباما – بإبقاء السياسة الأميركية في خانة «اللافعل» و «ليس الآن».
هذا لا يعني ان الانتهاء من إجراء الانتخابات في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)
سيؤدي تلقائياً الى سياسة أميركية حازمة ومجهزة بإجراءات حاسمة. المسألة
ذهنية بقدر ما هي سياسية. الدائم في الخطوط العريضة لتوجهات الولايات
المتحدة الأميركية يدوم بغض النظر إن كان الديموقراطي أوباما أو الجمهوري
رومني في المكتب البيضاوي. وفي الوقت الراهن، أميركا ليست في عجلة لإعادة
رسم دور لها يضعها في واجهة المواجهة. انها مرتاحة في مرحلة التغيير في
المنطقة العربية. وهي لا تبدو في حالة رعب من تصادم إيراني – إسرائيلي، بل
تبذل جهدها لئلا تقع في مخالب استدراجها الى شن عمليات عسكرية ضد مواقع
نووية إيرانية. أركان السياسة الأميركية لا يقرأون مواقف روسيا والصين
بهلع، بل يحجّمون الاستكبار الروسي بتصنيفه رد فعل الضعيف على أساس تقويم
لمدى انحسار النفوذ الفعلي لموسكو مع النظام في دمشق. انهم غير قلقين من
صعود الإسلاميين الى السلطة في أماكن التغيير في المنطقة العربية، وهم لا
يعيرون طبول الذعر من تفشي «القاعدة» في سورية أهمية. هكذا يريد أركان
السياسات الأميركية العريضة الإيحاء للآخرين. إنهم في مرحلة استبعاد
الانجرار من دون أن يقعوا ضحية أنفسهم نتيجة سياسة الاستبعاد، فالمؤسسة
الأميركية الحاكمة بما فيها العسكرية والاستخبارات ليست في وارد
الانعزالية، بل هي تَنْحَتْ للولايات المتحدة وجوداً استراتيجياً في أكثر
من مكان في الشرق الأوسط. وهذا ما يساهم في اشتعال أركان الحكم في روسيا
غيظاً وغيرة. التناقضات والازدواجية في المواقف الأميركية والروسية ليست
أقل مما هي في مواقف الصين أو الغرب أو المواقف العربية، أو التركية، أو
الإيرانية. الجميع يتلاعب بالقوانين والأعراف الدولية إما كذريعة أو كمبرر.
روسيا والصين تتمسكان بالقانون الدولي في دعمهما سيادة النظام في دمشق تحت
غطاء دعم سيادة الدولة وبإصرارهما على عدم جواز التدخل في شؤون الدول
الأخرى متناسيتين تماماً عمداً ان المعاهدات الدولية تضع مسائل منع المجازر
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فوق كل الاعتبارات. الحكومات الغربية
بدءاً بالإدارة الأميركية تبدو مهرولة الى الأمام وهي تقنن مبادئ حقوق
الإنسان والأحوال الشخصية في الدرجة الثانية من اعتبارات المصالح. تركيا
تتبنى سياسة متذبذبة تارة ترفع نصف عصا وتارة تخضع لرعبها من العنصر
الكردي. العرب منقسمون في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من صعيد، تارة يبدون في
غاية الحماسة لإحداث تغيير جذري في سورية وتارة يخضعون للروزنامة
الانتخابية الأميركية وما تطلبه واشنطن من اللاعبين المحليين.
الرئيس المصري محمد مرسي خرج ببدعة الحل الإقليمي للمسألة السورية كأنه
اخترع البارود أو كأن الأزمة السورية ما زالت في مرحلة التظاهرات السلمية
والمطالبة بالإصلاح. بدا الرئيس المصري ارتجالياً عندما طرح فكرة الحل
الإقليمي الحصري على أيدي كبار الدول في المنطقة – السعودية وايران وتركيا
ومصر. طرح الفكرة وكأنها خطرت له في خضم إلقائه خطاباً أثناء القمة
الإسلامية في مكة، ولم يتقدم منذ ذلك الحين بأية آلية تفيد بأن الفكرة
مدروسة وليست وليدة التسرع.
الرئيس المصري ابن الإخوان المسلمين لربما أراد أن تبدو الديبلوماسية
المصرية ناشطة وحيوية ومركزية، إلا انه في هذا الطرح المتسرع غير المدروس
بدا انه يتوهم دوراً لمصر ليست قادرة عليه في هذا المنعطف، فمصر ما زالت
تحت العناية الفائقة وهي غير قادرة على استئناف دورها التقليدي التاريخي
مهما بلغ العنفوان الوطني لدى الرئيس المصري أو غيره. ثم انه قد فات الأوان
على حل إقليمي مصري يستبعد الولايات المتحدة أو روسيا. هذا إضافة الى ان
العلاقات السعودية – الإيرانية – التركية قد دخلت مرتبة جديدة لم يعد في
الإمكان معالجة حدتها في حلقة الدول الاربع التي اقترحها الرئيس المصري.
هذا إضافة الى التناقضات والخلافات الجذرية مثل مطالبة الرئيس المصري
للرئيس السوري بشار الأسد مغادرة السلطة من جهة واعتبار القيادة الإيرانية
استمرار الأسد ونظامه في السلطة في صميم المصلحة القومية الإيرانية.
ذهاب مرسي الى طهران للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز لم يأتِ في إطار
تفعيل اقتراحه الارتجالي بآليات تنفيذ، ولم يدخل في خانة الإصرار على
القيادة الإيرانية بالكف عن مد الدعم العسكري والاقتصادي للنظام في دمشق
وللرئيس الذي دعاه مرسي لمغادرة السلطة.
لعله ذهب الى إيران ليثبت انه ليس تحت تأثير الولايات المتحدة، علماً أن
الانطباع الذي يتعمق لدى الكثيرين في العالم هو ان علاقة متينة تنشأ منذ
فترة بين الأميركيين والإخوان المسلمين في مصر وخارجها. أراد مرسي ان يوحي
عبر زيارته الى طهران بأن مصر دولة مستقلة لا تتأثر بالضغوط الأميركية وأن
محمد مرسي لا يستسلم للضغوط الأميركية والغربية وحتى العربية.
كان في وسع الرئيس المصري إيفاد وزير خارجيته الى طهران. اختار غير ذلك
مساهماً عمداً في دفعة دعم لصدقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قيادة
حركة عدم الانحياز ومساهماً جذرياً في إعادة تأهيلها وفك العزلة عنها.
فذهاب رئيس ينتمي الى الإخوان المسلمين في مصر الى طهران الملالي ليس أمراً
عادياً، إنما هناك قاسم مشترك بين الإخوان في مصر والملالي في إيران وهو
الظهور – أو التظاهر – بأنهم ضد الولايات المتحدة. واقع الأمر ان كليهما
يريد علاقة ثنائية مميزة مع واشنطن ويسعى الى ذلك عبر مختلف الطرق
والآليات.
أسرة صنع القرارات المعنية بالسياسة الخارجية الأميركية تبدو راضية بإدارة
العلاقات مع ملالي طهران وتهذيب العلاقات مع الإخوان أينما كان. أحد
المخضرمين في تلك الأسرة اعتبر ان الحذاقة الاستراتيجية لدولة كبرى تكمن في
إدراك متى تستفيد مما تخلّفه رياح التغيير. اعتبر ان روسيا خاسرة لأنها
جعلت من صعود الإسلاميين الى السلطة كابوساً شخصياً لها. أشار أيضاً الى
انحسار أدوات التأثير لدى موسكو في مرحلة التغيير في المنطقة العربية حتى
إزاء حليفها في دمشق، إذ انها تأبى الليونة والانخراط دولياً لأنها غير
قادرة على التأثير الفعلي عملياً في أركان النظام في دمشق. وبالتالي، انها
تفضل أن تكابر وتبدو صعبة على أن تبدو متعاونة ثم تلقى إفشال جهودها
وبالتالي تحجيمها الى لاعب ضعيف غير مؤثر.
هذا التقويم لافت في حال كان صحيحاً ودقيقاً أو في حال كان هدفه تلويث سمعة
روسيا أكثر فأكثر. الواضح ان التفاهمات الدولية وصلت حائطاً مسدوداً وأن
أجواء الحرب الباردة تسود. موسكو تتصرف وكأن سورية باتت خطاً أحمر وهي
تتمسك بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وبضرورة احترام السيادة. ولعل
هذين المبدأين في صلب مشاغلها المباشرة لأنها تخشى ان يصل «الموسى الى
ذقنها».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنيف في مواقفه لدرجة ان هناك خوفاً جدياً
لدى البعض من إمكانية قيامه بمغامرة المواجهة العسكرية على نسق ما يسمى بـ
«حرب الكلاب» أي النهش القاتل بلا استراتيجية. وهذا الخوف يبرز عند الكلام
عما يسمى بـ «نموذج كوسوفو»، أي التدخل العسكري عبر بوابة الواجب الإنساني
والمعاهدات الدولية التي تضع مسؤولية التدخل الإنساني فوق اعتبارات
السيادة.
هذه البوابة متوافرة فقط عبر الحدود التركية – السورية. ومثل هذا التدخل
ممكن فقط في حال اتخذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثل هذا القرار أو في حال
طلبت تركيا معونة الناتو على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع
عن النفس. وسائل وأدوات نموذج كوسوفو تشمل المناطق الآمنة، والممرات
الإنسانية، وفرض حظر الطيران دعماً لمنطق التدخل الإنساني. اللاجئون محرك
لمثل هذا الإجراء انما هناك أيضاً محركات أخرى. تركيا تمتلك مفتاح تفعيل
نموذج كوسوفو، لكن الأتراك خائفون ومترددون في سياسة نصف العصا، واغتنام
الفرص، وتطويق الطموحات الكردية، والخوف العارم من حقوق مواطنة الأكراد.
موسكو تجابر وتكابر. انها الآن تطالب بالتحقيق في أعمال العنف «الهمجية» في
سورية وهي ما زالت تمد المعونة العسكرية للنظام الذي يرتكب عنفاً همجياً.
إطالة النزاع عززت من عسكريته كما ساهمت في دخول التطرف الإسلامي فاعلاً في
الساحة السورية، وموسكو طرف فاعل في إطالة النزاع. لربما موسكو تفضل
«الأفغنة» على «الكوسفة» ولعلها تنظر اليهما بأنهما الشيء نفسه. لكن
المعارضة المسلحة السورية تشكل ذخيرة غنية لموسكو إذ انها تنشر صورها
دائماً بشعارات ترافق الأسلمة المتطرفة كلما شنّت عملية عسكرية.
بين الارتجالية والاسترضاء يتأرجح مستقبل سورية على التسرع والتعنت وخطوط
حمر لدول كبرى ولاعبين إقليميين كل منهم يتموضع في خريطة إقليمية جديدة لم
تكتمل معالمها بعد. حتى الآن، لا أحد يعرف متى تنتهي آلام سورية – بعد
الانتخابات الأميركية، آخر السنة، بعد شهور، قبل سنتين؟ اليقين الوحيد، وهو
بدوره يقين عابر، انه لن يحدث أي تغيير نوعي قبل تلك الانتخابات الرئاسية.
|