|
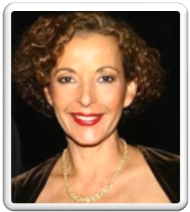  مقالات
سابقة للكاتبة مقالات
سابقة للكاتبة
راغدة درغام
(ولدت في بيروت سنة 1953) صحفية و محللة سياسية لبنانية-أمريكية تعمل مديرة
مكتب جريدة الحياة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ 1989
اكلاف الفيتو الروسي الثالث في مجلس الامن
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٢
ماذا أمام كل من موسكو وطهران بعدما دخلت القيادتان الروسية والإيرانية
عينَ العاصفة في أعقاب الخسارة الفادحة لكل منهما عبر البوابة السورية؟
القيادة الإيرانية أفرطت في شروطها ومماطلتها في الملف النووي، كما في
إصرارها على حقها بهيمنة إقليمية، فخسرت. والقيادة الروسية هسترت في عاطفية
قومية وأفرطت في إطالة الأزمة السورية تحصيناً لمطالبها ولتموضعها في
المنطقة وفي المفاوضات، فباتت أوراقها أضعف وبدت سمات الخسارة الإستراتيجية
على ملامحها ومواقفها. فأيهما سيكون سبيل استدراك الأمور لكل من موسكو
وطهران: المواجهة أم الاستدراك؟ وإن كان حقاً لم يفت الأوان على إصلاح
سياستيهما، فهل ما زال هناك هامش جدي أمام إتمام الصفقة الكبرى، أم أن
النظام الإقليمي الجديد انطلق الآن بوتيرة أسرع تاركاً وراءه الدب الروسي
غاضباً وملالي طهران في حالة استنفار؟
القيادة الروسية ارتكبت خطأ مميّزاً قبل أسبوع عندما استخدمت الفيتو في
مجلس الأمن للمرة الثالثة لمنع الأسرة الدولية من إنذار النظام في دمشق من
أبعاد استمراره في الممانعة الدموية. الفيتو الصيني الذي تزاوج للمرة
الثالثة مع الفيتو الروسي ليس أقل وزناً في مجلس الأمن، إنما الصين أقل
عنفاً في مواقفها نحو سورية مما هي روسيا. فالفيتو المزدوج يعكس الالتزام
الدائم بالحفاظ على علاقة التحالف الاستراتيجي بين الشيوعيين (سابقاً أو
حاضراً)، لا سيما في وجه امتداد ذراع الغرب – بالذات الولايات المتحدة –
إلى المناطق الإستراتيجية الغنية بالنفط والغاز والمهمة تاريخياً. لكن
الفارق واضح بين الدور الروسي في سورية وبقية منطقة الشرق الأوسط وبين
ابتعاد الصين عن دور مماثل واكتفائها بدعم روسيا في مجلس الأمن. وللتأكيد،
أن الأذى المواكب للفيتو الصيني ليس أقل من ذلك الملازم للفيتو الروسي.
فكلاهما عطّل قدرة مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته وساهم في إطالة محنة
سورية وزيادة ضحاياها بآلاف وآلاف.
قد يكون الفيتو الصيني فيتو المجاملة مع روسيا أو فيتو التحالف الموجّه ضد
الغرب، إنما الصين ليست ضالعة في سورية وإيران – سلباً أو إيجاباً – كما
روسيا. بكين لن تتورط أكثر، لا سيما بعدما انهارت جهود الصفقة الكبرى على
ذبذبات الهستيريا الروسية التي انطلقت في أعقاب الانفجار الأمني الضخم في
دمشق الأسبوع الماضي وتمثلت في قرار استخدام الفيتو الروسية بدلاً من
التقاط الفرصة النادرة لتكون موسكو في صدارة رعاية التحوّل في سورية وفي
عمق الشراكة في صوغ النظام الإقليمي الجديد.
كثيرون راهنوا على حكمة القيادة الروسية واغتنامها الفرص المواتية لمصالحها
ومكانتها وموقعها في منطقة الشرق الأوسط. كثيرون اعتقدوا أن الإطالة كانت
جزءاً من فن التفاوض للحصول على أكثر – ثنائياً مع الولايات المتحدة
وإقليمياً مع دول المنطقة. كثيرون افترضوا أن موسكو لن تهدر فرصة نادرة لها
لقيادة صناعة البديل في دمشق – أو على الأقل لمشاركة جذرية لها في صنع
البديل.
تحت عنوان العاطفة القومية والعنفوان الوطني، ثارت مشاعر الديبلوماسية
الروسية وغلبت على المنطق الذي كان أجدى بموسكو أن تلجأ إليه مهما ثار
غضبها، بحق كان أو بباطل. ذلك الفيتو المشحون بالغضب المثقل بالعاطفة
والعنفوان قضى أيضاً على المبعوث الأممي والعربي، كوفي أنان، الذي كان
يتصرف منذ البداية استرضاءً لروسيا بأمل كسب تعاونها في إبرام حل سلمي في
سورية يلمّ شمل الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن. فيتو
موسكو في مجلس الأمن قضى على مهمة كوفي أنان وعلى الرجل نفسه الذي خرج
خاسراً، اسمه مقترن بالإطالة وبالحذر والحرص على مصالح روسيا وإيران أكثر
من مصير سورية.
كوفي أنان مسؤول عن نفسه وعما اختاره من سياسة وإستراتيجية لتنفيذ المهمة
الموكلة اليه من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. لعله يعتقد أنه
أُفشِلَ ليس عبر الفيتو الروسي وإنما نتيجة المواقف العربية والغربية
والتركية. لعله مقتنع بأنه لو أفلح في إقحام دور الجمهورية الإسلامية
الإيرانية رسمياً على طاولة التفاوض حول المستقبل في سورية، لما آلت الأمور
الى ما هي عليه. إنما، لعله بدلاً من ذلك قد توصل إلى استنتاج بأنه أخطأ في
تصوّره لمهمته، كما في رهانه على صدق النظام في دمشق، كما في اعتقاده بأن
أسلوب الإبحار الحذر المميز به كان ممكناً وسط تراكم جثث السوريين آلافاً
بآلاف.
قد لا يكون فات الأوان على مسار تصحيحي يُصلح السمعة التي تلاحق كوفي أنان
الآن. إنما ذلك يتطلب نفضة جذرية في ذهن الرجل تأخذ في الحساب انحسار الوزن
الروسي في المعادلة وانحسار الدور الإيراني في المنطقة. فكوفي أنان أيضاً
خسر فرصة نادرة بأن يصبح لاعباً أساسياً في صوغ النظام الإقليمي الجديد.
لقد اصطف في الخندق الخاسر – أقله حتى الآن – وفي اصطفافه هذا، أثار النفور
ليس فقط لدى جزء كبير من الشعب السوري وإنما أثار أيضاً نفور دول عربية ذات
وزن كبير بالذات داخل مجلس التعاون الخليجي.
فالمعادلة اختلفت بعد الفتيو الروسي – الصيني الثالث. الولايات المتحدة
خفّضت جذرياً أية ثقة لها بصدق النيات الروسية وبحل سلمي في سورية مبني على
ضغوط روسية على الرئيس بشار الأسد للتنحي عن السلطة عبر عملية سياسية
انتقالية. وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لم تقفل الباب أمام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف ولا في وجه بشار
الأسد. تحدثت عن «ملاذ آمن» بلغة عدم فوات الأوان، تاركة هامشاً للاستدراك
يضيق أفقه الزمني بسرعة. كذلك الدول العربية لم توصد الباب وإنما بادرت
للمرة الأولى إلى تقديم ممر آمن لمغادرة الرئيس السوري وعائلته السلطة
والبلاد. إنما كل هذا يفيد بأن لا مجال أبداً لما أرادته القيادة الروسية
والإيرانية والسورية، أي بقاء الأسد في السلطة الى حين استكمال العملية
السياسية الانتقالية. فات الأوان. إن الكلام الآن يصب في خانة التنحي كجزء
أساسي من عملية نقل السلطة في سورية.
يلازم ذلك قرار استراتيجي، إقليمي وغربي، بمباركة تسليح المعارضة. الولايات
المتحدة والدول الأوروبية لن تسلّح المعارضة، لكنها ستعزز ما تساعدها به من
معلومات استخبارية خارقة وما يشابهها. الفيتو الروسي – الصيني أجبر واشنطن
على احتضان خيار مباركة التسليح، ذلك أن الفيتو نسف ما تم الاتفاق عليه في
جنيف، بما في ذلك التوافق على عدم عسكرة النزاع.
سيرغي لافروف يتحدث بلغتين ما بعد ذلك الفيتو الخاطئ. انه يتحدث بلغة خشبية
معهودة يرافقها كلام عن أن العسكرة والتسليح يعنيان دعم انطلاق الإرهاب
الإسلامي في الساحة السورية وعلى رأسه «القاعدة». ومن ناحية أخرى، يترك
الباب مفتوحاً على احتمال استدراك موسكو أخطاءها لتقدم إلى الغرب والعرب
دوراً يجعل من غير الممكن الاستغناء عنها، دور العرّاب الحقيقي لما بعد
تنحي بشار الأسد عن السلطة ولمعالم النظام البديل في دمشق.
الانشقاقات العسكرية والديبلوماسية وفي أوساط العائلات الموالية تقليدياً
لنظام الأسد، مثل عائلة طلاس، أطلقت بدورها خطوة نوعية أخرى في الساحة
السورية. وموسكو لا بد أنها تراقب بقلق. تراقب انزلاق فرصتها بأن تكون
جزءاً من النظام الإقليمي الجديد بدلاً من وقوفها خارجه مُتهمةً بأنها خذلت
الشعوب، وأطالت صراعات أدت إلى تغذية التطرف الإسلامي ودخول عناصر
«القاعدة» إلى الساحة السورية عبر البوابة العراقية. بل أكثر. أن ما كانت
تخشاه موسكو وكانت محقة في إبراز معارضتها له بناءً على مصالحها المشروعة
بات وارداً بسبب المواقف الروسية نفسها. ذلك أن عسكرة النزاع في سورية أتت
بالتأكيد نتيجة المواقف الروسية الممانعة.
إقليمياً، خسرت روسيا خسارة كبرى وهي تشاهد تحالف الأمر الواقع بين الدول
العربية ومن ضمنها مجلس التعاون الخليجي، ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن
ضمنها تركيا. مصر باتت النموذج للتوافق والاتفاق بين هؤلاء اللاعبين على
أساس نموذج التعايش والمحاسبة المتبادلة بين الجيش وبين الإسلاميين في
السلطة. أميركا تبدو شريكة طموحات الشعوب، فيما من وجهة نظرها تتأقلم مع
واقع جديد يجعلها تستخدم «الإسلام المعتدل» لمحاربة التطرف الإسلامي، فتضمن
بذلك موطئ قدم لها مع الذين في السلطة، وتبدو متعاطفة مع الشعوب ومع
التحولات الديموقراطية، وتضمن مصالحها البعيدة المدى في الوقت نفسه.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشريكة للنظام في سورية ولروسيا، خاسر
كبير جداً في ما آلت إليه الأمور بعد الفيتو الروسي – الصيني. واشنطن وافقت
أخيراً على ما كانت قاومته لفترة طويلة، وهو تبني إستراتيجية قصم ظهر طهران
في سورية لتطويقها وسلبها طموحات إقليمية تشمل مطلاً استراتيجياً لها على
البحر المتوسط. طهران خاسرة لأنها كانت استثمرت غالياً، مادياً وعسكرياً،
في سورية لتكسب ذلك الموقع الاستراتيجي.
فالجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت مطوّقة من الداخل بمعارضتها، ومن
الخارج عبر حظر نفطي غربي مؤلم، أو في أواصر مواقع نفوذها الإقليمي.
نووياً، أنها تحت رحمة تكنولوجيا التخريب المتفوقة التي قد لا تضطر إسرائيل
أو الولايات المتحدة لشن عمليات قصف محددة لمواقع نووية في إيران. انها على
عتبة اندلاع انتفاضة إيرانية بعد استكمال الانتفاضة السورية. العراق الذي
كان يعتبر حديقتها الخلفية تبدو عليه ملامح الواقعية واستعادة مكانته
العربية وهو يقرأ جيداً معنى تعميق الخيار الاستراتيجي بين دول مجلس
التعاون الخليجي وحلف شمال الأطلسي وانعكاسه على مصير إيران وتقزيمها
إقليمياً. والآن، وبعد الفيتو الروسي – الصيني، لا دور لطهران على طاولة
المفاوضات على مستقبل سورية، كما أرادت موسكو وسعى وراءه كوفي أنان.
التهديدات الإيرانية يجب أن تُؤخَذ بجدية، إنما ليس ضرورياً الافتراض ان
حليف طهران في لبنان، «حزب الله»، سيتصرف تلقائياً بما يخدم طهران ويؤذيه
جذرياً في بنيته التحتية في لبنان في حال استفزاز إسرائيل لعملية عسكرية
ضده في لبنان. إسرائيل نفسها قد تقرر ان الفرصة مواتية لها للتخلص من سلاح
«حزب الله» في جيرتها المباشرة في لبنان. لكن هناك من يستبعد هذا الاحتمال
ويؤكد ان هناك نوعاً من تفاهم الأمر الواقع بأن لا «حزب الله» ولا إسرائيل
يريدان ان يخوضا حرباً في لبنان مهما كان ذلك في مصلحة النظام في دمشق أو
طهران.
روسيا أثارت الخوف من احتمال نقل انتقامها ونقمتها في اتجاه تقسيم في سورية
أو تصدير للنزاع إلى لبنان أو تحريض على مواجهة إيرانية – إسرائيلية عبر
حروب بالنيابة. لكن روسيا تبقى دولة كبرى لن تتحمل مسؤولية حروب لعلها تشهد
استخدام أسلحة كيماوية غير شرعية. لذلك انضمت روسيا إلى الدول الغربية التي
حذرت دمشق من استخدام هذه الأسلحة.
ماذا ستفعل روسيا بعدما خسرت أوراق نفوذ ومساومة ومقايضة قوية، بما فيها
ورقة محورها مع دمشق وطهران في مفاوضاتها الثنائية مع الولايات المتحدة؟
الإجابة تكمن في ما إذا كانت القيادة الروسية اعترفت أمام نفسها بالخطأ
الفادح الذي ارتكبته في الفيتو الثالث، وبالتالي بإمكانها الاستدراك
لاستعادة بعض زمام المبادرة. أما إذا تصلبت معتقدة أنها محقة في هذه
السياسة، فستقودنا أجواء الحرب الباردة الجديدة الى مواجهة وتطرف وحروب
بالنيابة وحروب استنزاف ستكون مكلفة ليس فقط للمنطقة وإنما أيضاً لروسيا
نفسها في عقر دارها، وجيرتها، وفي مكانتها العالمية.
|